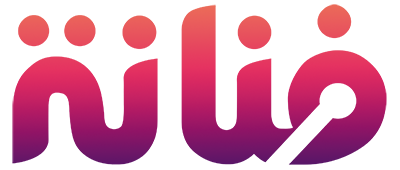أحيانا تنقسم حياة الواحد منا إلى ما قبل وبعد واقعة استثنائية ما، سواء كانت مُفرحة أو مؤلمة، و”زينايدا سيريبرياكوفا (Zinaida Serebriakova)” لم تكن استثناء من ذلك، فعلى مدار سنواتها الاثنتين والثمانين، تقلبت الفنانة الروسية بين أحوال ثلاث، من زواج هانئ إلى عوز وثورة، ثم إلى مهجر، حتى وجدت مستقرا لها في المغرب العربي.
استُدرجت زينايدا إلى الفن على حين غرة منها، فهي سليلة العائلة الروسية العريقة “لانسيراي”، التي عُرفت بسريان الفنانين والنحاتين والمعماريين فيها. ولدت سنة 1884 لأب نحات هو “يوجين لانسير” الذي برز بشكل خاص بفنه التشكيلي، أما جدها فكان “نيكولاي ليونيفيتش بينوا” أكاديمي الهندسة المعمارية، في حين أن عمها ووالدتها كانا كذلك فنانين مغمورين(1)(2)، وقد عملوا جميعهم في منزل ذي أجواء صاخبة وطوابق متعددة، به مجموعة من الكتب واللوحات.
تعارضت نظرتها التشاؤمية للأمور مع سيماء وجهها المضيء، بعينيها العسليتين المتسعتين اللتين زادهما الشجن اتساعا، واتصفت طباعها بالجدية والمثابرة والخجل المقرون بثقة محدودة في النفس وتشكيك دائم في موهبتها. وكلما تقدم بها العمر استوطنتها هذه الجوانب أكثر، إلا أنها تمتعت دوما بدعم المقربين منها ورعايتهم لموهبتها التي كانت مرئية للجميع.
برحيل جدها وهي دون الرابعة عشرة، انتقلت مع والدتها إلى منطقة ريفية في موسكو، تقع اليوم على أراضي أوكرانيا. في تلك الفترة، أُتيح لها أن تطالع المرتفعات المصفرة واخضرارها، تلال وطواحين الهواء التي تلتف حولها سنابل القمح المحنية والبيوت البيضاء المنتصبة من بعيد كحبات اللؤلؤ، فكان وقع ذلك عليها كوقع الماء على الأرض اليابسة، إذ أمضت غالبية نهارها مع الفلاحين والعاملين في الحقول، ولم تتردد في المشاركة في الحصاد، وصورت كل ذلك في رسومها.
في البدء كان الحب
وفي مدرسة الفنون الخاصة بالأميرة “تينيشيفا”، التقت زينايدا بـ”إيليا ريبين”، أحد أرفع الرسامين الواقعيين في القرن التاسع عشر(3)، وسرعان ما أصبح مرشدا لها. ثم تقابلت مع رسام البورتريه “أوسيب براز”، صاحب البورتريه الشهير للكاتب الروسي “أنطون تشيخوف” الذي يتصدر أغلفة مؤلفاته. كان “براز” يعتقد أن أفضل طريقة للتعلم هي بتكليف زينايدا بنسخ لوحات معروضة في متحف الأرميتاج في سانت بطرسبرغ، والذي يضم أكبر مجموعة من اللوحات في العالم، واستكشاف ثراء موادها ودقة ألوانها، وكذلك حثها على العمل بشكل وثيق مع الطبيعة، وقد ساعد ذلك زينايدا في إتقان تقنيات الأساتذة العظماء، وترك بصمة قوية عليها.
تمر الأشهر والسنوات وتمسي زينايدا رسامة متمكنة من أدواتها، تزخر أعمالها بالمشاعر والشغف الذي ظهر في رسومها للقرية والفلاحين والبساتين المقابلة لنهر مورومكي الذي يقع بين التلال المنحدرة. كما بدأت أعمالها تعكس دفء المشاعر الذي مسها بفضل تطور علاقتها مع بوريس سيريبرياكوف، ابن عمها وزوجها المستقبلي الذي أنجبت منه أربعة أبناء.
وفي أحد الأعوام، افترش الثلج الناصع الأفنية والحقول، فحال ذلك بينها وبين الحصول على نماذج قروية ترسمها، فانحسرت رؤيتها إلى الداخل نحو ذاتها، لتسفر عن إحدى أهم لوحاتها -بوصفها رسامة بورتريه- التي عُرفت باسم “على منضدة الزينة (At the Dressing Table)”، وصورت فيها سمات جمالها الأُنثوي، جنبا إلى جنب القوارير والزجاجات والخرز ودبابيس الشعر(4).
في تلك اللوحة، تتجلى سيريبرياكوفا على الزجاج العاكس وهي تمسد شعرها الأملس المنسدل بكثافة. الحجرة من حولها ساطعة، يرتد فيها الضوء عن الجدران البيضاء والمنسوجات الباهتة والمرآة، لتشعر باندفاع في عينيها. أمامها شمعدان واحد وانعكاسه، بشمعة قد ترمز للدفء والراحة، وعلى حواف الصورة إطاران، واحد للمرأة وواحد للوحة. تأثيث الغرفة بسيط، جدران وباب أبيض ومغسلة، من أجل هذه البساطة على وجه الخصوص لاقت اللوحة قبولا، وتعتبر من أفضل الصور الذاتية في تاريخ الفن.
وثقت العديد من البورتريهات الذاتية للفنانة الروسية 14 عاما من السعادة، صورت خلالها زوجها وهو غارق في القراءة، وأطفالها وهم مستغرقون في أنشطتهم. ففي لوحة “عند الإفطار” يظهر ثلاثتهم، دون الرابعة، يستدير أكبرهم سنا للنظر إلى وجه أمه، يبدو الأمر كما لو أنه ينتظرها لتنضم إليهم وتنال حصة من الطعام، فهو نفسه قد شرع بالفعل في ارتشاف الحساء، بينما لا يزال شقيقه، زينيا، الطفل الأكثر هدوءا، يرتوي من المياه. على الجانب نرى يدَي الجدة تسكب الشوربة، وهي تفصيلة كفيلة بمدك بالأمان(5)، أما شقيقتهم الصغيرة فتضع راحتها المكتنزة مباشرة على صحن فارغ، ناظرة إلى والدتها الفنانة بتفحص. لا ريب أن المشهد بأكمله امتداد لإحساس الأم الجارف تجاه صغارها.
لكن الصخب الذي رافق تلك الحياة أعقبه صمت مطبق بعدما أطاحت ثورة أكتوبر أو الثورة البلشفية (أول ثورة شيوعية في القرن العشرين) في روسيا بجملة من الأوهام التي علق الشعب آمالا عليها. تعلقت عائلة لانسيراي بالثورة بداية، لكن ثرواتهم ألقت بهم في مهب النيران، إذ نُهبت وأحرقت ممتلكات الأعيان. وفي حمى النيران، خطت زينايدا لوحات عديدة، فغامت الألوان، واستبدلت بالألوان المائية القلم الرصاص. وبدا المنزل القائم على الحب والسعادة العائلية، هشا عرضة للانهيار تحت ضغط العواصف التاريخية.
هذا هو ما قدمته الفنانة الروسية في لوحة “بيت من ورق” التي أتت عقب إلقاء القبض على زوجها وإطلاق سراحه، ثم إصابته بحمى التيفود وفراقه للحياة(6). يحكي تبدل الملامح في اللوحة كيف تغيرت الحياة، في حين أن بيت الورق يعكس حياتها التي باتت غير مستقرة تماما ومُزعزعة.
جهدت سيريبرياكوفا لصرف الوجع أو اجتنابه، اقتضت الأوضاع المُلحّة منها أن تدر المال من بيع أعمالها، لكن الأمور ازدادت سوءا، فكتبت رسالة لعمها تقول: “لو أنك تعلم كيف أحلم وأتوق للمغادرة لتغيير هذه الحياة بطريقة ما، كل يوم لا يوجد سوى الحاجة الماسة للطعام (والذي عادة ما يكون غير كاف وذا نوعية رديئة). صارت أرباحي ضئيلة للغاية لدرجة أنها لا تكفي حتى لأبسط الأشياء. طلبات الصور نادرة بشكل رهيب وهم يدفعون بنسات تضيع قبل أن تصبح الصور جاهزة”.
رحلتان إلى مراكش
دفعتها هذه الأوضاع البائسة إلى البحث عن مُتنفس عبر الهجرة. عرجت على الأراضي المغربية من الدار البيضاء إلى مراكش، حيث نزلت فيها خلال رحلتين قامت بهما عامي 1928 و1932، نبذت فيهما القلم الرصاص واللون الرمادي، وانحازت إلى ألوان الباستيل الزيتية. فبلغت أعمالها حينها نحو 200 عمل عُرفت باسم الدورة المغربية(7).
رسمت صورا حية لا لبس فيها للعرب والأفارقة في المغرب، وحدهم أو مع أطفالهم، يرتدون ملابس تقليدية، في محيطهم المألوف. شغلتها حياة الشرق بالتقاليد والعادات اليومية التي أحاطتها، وأسرتها خصوبة الطبيعة وأسوار المدينة وسفوح أطلس وقرية تامسولت، فصنعت إسكتشات سريعة من التجار والموسيقيين والمدخنين ومحتسي الشاي والحرفيين والمغاربة الأصليين والأشخاص من جنسيات مختلفة في الزي التقليدي.
أتيح لها أحيانا أخذ راحة تحت شجرة البندق، لتظهر مهارتها في التركيب الدقيق، حيث وزعت التركيز السردي لتُظهر الوجوه والأشياء ورؤوس الجمال، بما في ذلك تلك التي تبقى في الخلفية. حققت زينايدا درجات متفاوتة من التركيز، ورغم أنها غالبا ما كانت ترسم الأشكال فقط وتقدم تلميحات ثلاثية الأبعاد، فإنها حافظت على الواقعية، الأمر الذي ميزها عن العدد الكبير من الفنانين المستشرقين الآخرين في عصرها.
في رسالة موجهة إلى أخيها يوجين، كتبت: “تأثرت بكل شيء هنا إلى أقصى حد، بالأزياء وبكل لون ممكن، وبجميع الأجناس البشرية المندمجة معا، الأفارقة والعرب واليهود والمسيحيين وما إلى ذلك. الحياة التي يعيشونها في مراكش لا يمكن تصورها أيضا، كل شيء مصنوع يدويا تماما كما كانت الأمور منذ ألف عام. أما ساحة السوق، فيشغلها يوميا آلاف الأشخاص الجالسين في دوائر على الأرض، ويتجمهر العوام لمشاهدة الراقصين وسحرة الأفاعي”.
ليست لوحة “الصبي المغربي (Moroccan boy)” سوى مثال على براعة زينايدا في التكوين وارتكازها على التفصيل، فوجه الفتى ويداه المتشابكتان لا تتطابق درجاتهما، هناك سواد عليهما عُبّر عنه بالفحم، وهو ما يجعلنا نتكهن أن ذلك الصبي يعمل بيديه في الأرض. ويبدو كذلك أنه يعيش في بيئة صحراوية، والنخلات والأشجار تنبت خلفه. وقد امتدت تلك الألوان الترابية إلى اللباس المغربي التقليدي الفضفاض الذي صور بخطوط سريعة ولكن ناعمة.
في لوحة “الفتاة المغربية والطفل الصغير (Moroccan Girl and Infant)”، تصور زينايدا طفلة صغيرة تحمل بالكاد طفلا يصغرها، أقرب ما يكون إلى أخيها. ويخيل إليك أنها تبدو كما لو أن هناك ما يشغل تفكيرها، هَمّ غير مرئي يلقي بثقله عليها، ربما تفكر في غد ذلك الرضيع. ينعكس على محياهما قلق شديد، ورغم ذلك ترفض الألوان أن تنطفئ، واعدة بأمل متجدد تستبدل فيه بتلك الأعين القلقة الحائرة أخرى ضاحكة.
بعد ذلك، انتقلت سيريبرياكوفا إلى باريس، لكن تأثير المغربي ظل جليا عليها، فسرعان ما افتتحت معرض رحلة إلى المغرب. وأشادت الفنانة :قسطنطين سوموف: بعملها قائلة: “في معرض زينايدا هناك إسكتشات من الطبيعة صنعت خلال رحلتها الأخيرة إلى المغرب، البعض منها جميل جدا وحيوي بالألوان”. ووصفته الناقدة الفنية “لولي لفوف”: “زينايدا قدمت لنا سلسلة طويلة من انطباعاتها المشعة والمليئة بالحياة عن المشاهد العجيبة لمراكش بمجموعة رائعة من ألوان الباستيل، بارعة جدا في تصوير الجمال الذي لا مثيل له لتلك الأرض الأفريقية”.
ذاب الجليد في روسيا وتشكّل من جديد، إلا أن زيناديا لم تعد إلى هناك أبدا، وبقيت ذكرى المغرب وتأثيرها جليين في أعمالها التي جمعت فيها المغاربة والفلاحين العرب مع الروس، وزينتها بوجوه أبنائها الذين طال انتظارها لهم لعلهم يُبعدون عنها وحشة المنفى.
*المصدر: الجزيرة نت ( سلمى نبيل )